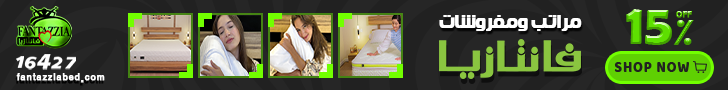الجار الذي مات وحيدا
جاء الموت بما فيه.. الموت، ذاك الهالة المخيفة المتدثرة بالرهبة، بقدر ما هي مقدسة في آنٍ واحد، يخطف الأعمار في لمح البصر.. لا يطرق بابًا بل يخلعه، لا يتوانى عن أداء مهامه، وهو ما لا أهابه بالضرورة، ولكن اليوم مختلف.
الموت اليوم كله مختلف، هذا الموت الذي رأيته ليس كما عهدته في القصص أو المآتم، ليس كما رسمته في هادئًا، صامتًا، محمولًا على الأكتاف، رائحته مختلفة، عفنة، مقززة، كحية مرعبة،، حية أحبت جارنا الهادئ والتفت حوله حتى خنقته.
جارنا، مصطفى، ضرير العين محدود الرؤية، ضعيف البنية، وحيد الحال، واه على الوحدة ومفعولها في بني الإنسان.
تلك البلوة التي سطرت في قدر صاحبنا، وكانت أشد وطأة من فقره وضعفه وذهاب بصره،، وحدته التي جعلت منه فريسة سهلة للموت.
نعم، مات جارنا المسكين، مات وحيدا بسردية أبشع من حياته وحيدا، هكذا كان يسير بيننا كظل لا يطرق بابًا ولا يُطرق بابه.. مات في صمتٍ أثقل من حياته.
وفي شارع بسيط لا يتسع بضعة أمتار، اكتظ قاطنيه صباح اليوم ليكونوا بجانب مصطفى، هذا الجار الوحيد لم يعد وحيدا في الوقت ما بعد بدل الضائع.
في الحي الشعبي البسيط، اكتشف الناس وفاته، واكتشفت أنا سر الموت، فضلا عن اكتشافي استعاذات جديدة منه في دعائي خلافا عن الغرق والحرق واللدغ.
ونعود أدراجنا، شاهدت اليوم بأم عيني كم أن الوحدة قاتلة، في الوحدة موت مقنع، قتل صاحبنا الجميل ببط لمدة 20 يوما، تركته وحدته على فراشه طيلة هذه الفترة، وكانت الطرف الأقوى من طلب العون، ومن السؤال عن شاب (ارزقي) يجلس دائما على الناصية في انتظار مصلحة، وحتى الأقوى من رائحة عفنة تضرر منها أهل الشارع ومن كرامة الإنسان في دفنه.
وللعلم، في حيّنا، الضجيج لا يتوقف، الأطفال يلعبون، النساء يتبادلن الحديث من شرفات متقاربة، والدكاكين لا تغلق أبوابها.. ومع ذلك، استطاعت العزلة أن تبني جدارًا صامتًا حول مصطفى.
في شهر إلا أيام قلائل، تحلل صديقنا، خويت بطنه من أحشائها، وتآكلت جمجمته وتغيرت ملامحه، في هذا الشهر كان الموت ينام ويصبح وسط أهل الحي يراهم هو وقبيله من حيث لا يرونه، في هذا الشهر لم تصادف أن أقف يوما واحدا في شباك شقتنا المنتصب أمام بلكونته لأراه أو أشم رائحة قاتلته (الوحدة).
هبطت كل الأجهزة الأمنية إلى حيث أسكن، جاء أهل الشارع ملتحفين بالسواد، وحضر أهل المتوفى ،، أخته تبكيه، وأخوه غير الشقيق يتشاهد، وأنا أصرخ بصوت داخلي مبحوح لا تسمعه إلا أذني وروحي.
مات الجار، ذو الملابس البسيطة والتليفون النوكيا والسيجارة السلف، مات مُحدثا ثورة، رافضًا للهدوء الذي لطالما احتل حياته لسنوات طوال، مات منتقدا شح السؤال وبخل الود ومرارة النئ بالنفس عن الغير.
لم يكن مصطفى يحتاج مالًا، ولا طعامًا دافئًا – وإن كان هذا حقه – وارتضى بـ (العيش الفينو) وقطعة الجبن ملح خفيف، وكوب من الشاي يحتسيه على القهوة الكائنة بالجزء الأخر من الشارع، شاهدة على الحي برمته وأقدم من عمره وعمري مجتمعين، ولكنه كان فقط يحتاج "حضورًا بشريًا"، صوتًا يشق وحدته من حين لآخر.
أصبحت أعي كليا أنه ليست الوحدة في ألا تجد أحدًا، بل في أن تكون محاطًا بالبشر ولا يراك أحد.
مات جاري بصوت عالي صرخ للمرة الأخيرة في وجه العالم، فاستجابت لصرخته المشرحة وطلبته والطب الشرعي، ووقفت جميع الشوارع المجاورة وطل أصحاب البيوت من الشبابيك يودعون الوحدة ويلقون سلامهم الأخير على مصطفى.
ووقفت أنا أتذكر ملامحه، وسلامه ونبرته وجلسته بفم الشارع، وصعدت سلالم بيتي مسرعة أحتضن قططي وأمي، ونظرت للمرة الأخيرة على جارنا الذي لم يعد موجودا متمنية منه السماح ومودعة وحدته.
الأكثر قراءة
-
مات وهو صايم.. الساعات الأخيرة قبل وفاة النقيب عمر معاني في كفر الشيخ
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس 2026، استعلم الآن
-
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان بالاسم 2026، احصل عليها الآن
-
وثائق جيفري إبستين.. القصة كاملة
-
لماذا ورد اسم عالم الفيزياء ستيفن هوكينج في وثائق إبستين؟
-
أفضل رسائل التهنئة في ليلة النصف من شعبان 2026
-
نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات
-
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط مركز سمالوط
مقالات ذات صلة
ماذا يحتاج صن داونز للتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية؟
22 يونيو 2025 11:19 ص
أكثر الكلمات انتشاراً