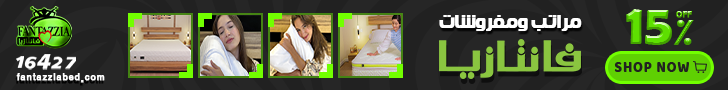الموساد، ما بين السقوط في فضيحة سوزانا وعبور فخ البيجر!
خلية سرية إسرائيلية من اليهود المصريين كادت تحرق مصر من الداخل في عام 1954، بل كادت تنسف اتفاق جلاء الجيش الإنجليزي عن مصر، بالإضافة إلى أنها حاولت مبكرًا تأجيج الخلاف بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فما حكاية سوزانا؟ وكيف غيّرت فصول نهايتها منطقة الشرق الأوسط؟
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كانت شمس الإمبراطورية البريطانية تغرب خلف التنامي المتصاعد للعملاق الأمريكي في الغرب، وراحت أشعة نفوذها الاستعماري تنسحب من العالم تدريجيًا. وكانت واحدة من أكبر قواعد الإنجليز العسكرية بالخارج، والتي كان قوامها يتجاوز الثمانين ألف جندي، تلك التي كانت تتمركز حول قناة السويس بجمهورية مصر العربية، تلك الجمهورية وليدة ثورة الضباط الأحرار في عام 1952.
وفي ذلك الحين، أصبحت هذه القاعدة تمثل العبء الأكبر اقتصاديًا وعسكريًا، بل وسياسيًا على حطام تلك الإمبراطورية؛ فقد كانت نفقتها تثقل كاهل الحكومة المنهكة بفعل الحرب، كما أن وتيرة المقاومة كانت تتصاعد تحت ظلال النظام الناشئ والمتطلع للتحرير الكامل والجلاء الكلي للإنجليز من مصر، مما زاد حملًا عسكريًا فوق الحمل الاقتصادي، إضافةً إلى تلك الصورة السياسية الذهنية الجديدة التي كانت تحاول بريطانيا ترسيخها في العالم كدولة تدعم الاستقلال وتعادي الاستعمار. كل تلك الأمور دفعت إلى اتفاق يوليو 1954 بجلاء الإنجليز التام عن مصر خلال 20 شهرًا.
في ذلك الحين، كانت طبول الحرب الباردة قد بدأت نغماتها تتعالى وسط ترقب أمريكي لموقف النظام المصري الجديد من هذا الصراع، وتدعم بحذر انحيازه تجاهها، وكانت تطلع بذلك إلى نفوذ قوي في الشرق الأوسط. كل هذه التغيرات العاصفة في العالم، وفي الشرق الأوسط خاصة، كانت تحت منظار ذلك الكيان الجديد الذي غرسته يد الاستعمار الإنجليزي في فلسطين، والذي كان يراقب عن كثب تلك التغيرات بتحفظ وتحفز، وكان هذا الكيان يدرك يقينًا أن استقلال واستقرار القطر المصري وتنامي قواه العسكرية والاقتصادية هو أكبر المخاطر التي تهدد وجوده.
وبما أن القاعدة البريطانية حول قناة السويس كانت تحول دون وصول الجيش المصري لحدود إسرائيل وتضمن سلامة الأخيرة، وأيضًا زرع بذور الخلاف بين القيادة المصرية والقيادة الأمريكية سيحول دون ذلك النمو العسكري والاقتصادي المتوقع في مصر، ولما استعصت الحلول العسكرية والسياسية المباشرة لإثناء بريطانيا عن الانسحاب أو إثناء الولايات المتحدة عن التفكير في دعم النظام المصري، كانت الاستخبارات هي الحل.
لذلك خططت المخابرات العسكرية الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار في مصر، وضرب المصالح البريطانية والأمريكية في الداخل المصري، عن طريق افتعال بعض التفجيرات والحرائق، وإلصاق التهمة بحركات سياسية ودينية مصرية، وليكون الموالون لإسرائيل من أبناء الجالية اليهودية في مصر هم السلاح الفاعل في ذلك، من هنا وُلدت سوزانا.
وبالفعل، في ربيع 1954، كلف مدير الاستخبارات "بنيامين جيبلي" الوحدة السرية 131 بجهاز الاستخبارات المسمى "أمان" بتنفيذ العملية التي أُطلق عليها "سوزانا". وبمجرد إصدار الأوامر، وبحسب الروايات، تحرك ضابط الاتصال الإسرائيلي إبراهام زئيف سيلع من أوروبا تحت اسم مستعار "أفري إيلاد" إلى مصر لتنشيط الخلية السرية 131، بقيادة ميدانية في القاهرة للطبيب الجراح موشيه مارزوك، وفي الإسكندرية بقيادة ميدانية للمهندس صموئيل عازار، وبعضوية حوالي سبعة أفراد آخرين بأدوار مختلفة، كما كُشف فيما بعد.
وفي الثاني من يوليو 1954، حمل فيليب ناتاس، أحد أفراد الوحدة في الإسكندرية، قنبلة محلية الصنع بالكامل، كان قد دربته المخابرات الإسرائيلية على صنعها عن طريق بول فرانك، وهو عميل إسرائيلي من أصل ألماني دخل مصر بجواز أوروبي، وكان مختصًا بصناعة العبوات. وتوجه فيليب نحو مكتبة تابعة للوكالة الأمريكية للمعلومات (USIS) في الإسكندرية، وغرس قنبلته هناك، قبل أن يفجرها عن بُعد، ليندلع حريق محدود تسيطر عليه السلطات المحلية بسرعة دون وقوع إصابات.
وفي الرابع عشر من الشهر نفسه، كانت الموجة الأكبر من التفجيرات، حيث استهدفت أربع عمليات متزامنة تقريبًا أربعة أماكن، هي: مكتب البريد الرئيسي، ودار سينما "ريو" بالإسكندرية، ومكتبة الوكالة الأمريكية للمعلومات، ودار السينما "مترو" في القاهرة. وقام بتنفيذها أربعة أعضاء آخرين من الخلية، وأسفرت العمليات عن حرائق محدودة سيطرت عليها قوات الدفاع المدني دون تسجيل إصابات، إلا أن تزامن وانتشار الانفجارات أصاب الأجهزة والشعب بالكثير من القلق حول الجهة المسؤولة والدوافع.
وفي الثالث والعشرين من يوليو نفسه، حمل فيليب ناتاس في حقيبته قنبلة جديدة، متوجهًا نحو مسرح محلي في الإسكندرية خلال احتفالات الثورة، إلا أن مواد القنبلة تسربت دون أن يدري، مما أدى إلى انفجارها وهو يحملها على سلالم السينما مباشرة قبل أن يدخل، وتشتعل النيران في جسده ووجهه، فتقوم السلطات بالقبض عليه.
وبالتحقيقات والتحريات، تنكشف كل خيوط سوزانا، ويقع جميع أفرادها داخل مصر في قبضة الأمن، لتعلن الجهات المصرية عن كشف الخلية رسميًا في الخامس من أكتوبر، وتبدأ إجراءات محاكمة المتهمين في الحادي عشر من ديسمبر 1954، ولتأتي الأحكام، سواءً بالإعدام أو المؤبد، على كافة الضالعين في الجريمة في السابع والعشرين من يناير 1955، ليسجل التاريخ الاستخباراتي واحدة من أكبر السقطات في تاريخ الجيش الإسرائيلي، زلزال هز كيان حكومة الاحتلال، بل قلب موازينها رأسًا على عقب.
ففي أعقاب تلك الفضيحة، ألقى رئيس جهاز "أمان" بنيامين جيبلي اللوم كله على وزير الدفاع في ذلك الوقت "بنحاس لافون"، الذي حملت الفضيحة اسمه فيما بعد، ليُطلق عليها "فضيحة لافون"، مما أدى إلى إقصاء الاثنين من المشهد فورًا، بل أطاحت تلك العملية برئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت "موشيه شاريت"، ليحل محله "بن جوريون".
ولم يقتصر الزلزال على الشخصيات والمواقع فقط، بل طال المؤسسات أيضًا، فقد تسببت فضيحة لافون في تحجيم دور "أمان" تمامًا، واقتصار دور هذا الجهاز على جمع المعلومات العسكرية فقط، فيما برز دور "الموساد"، الذي أُنشئ في العام 1952، ليصبح هو الجهاز المعني بجميع العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية بالخارج.
وطالت موجات الزلزال مصر، فقد كان أحد الأسباب الهامة في تهجير اليهود المصريين إلى إسرائيل فيما بعد، كما تسبب في اهتمام الحكومة المصرية في هذا الوقت بإنشاء جهاز استخبارات قوي، يستطيع التعامل مع التحديات الجديدة التي فرضها الواقع السياسي في ذلك الوقت.
وتُعد تلك العملية فصلًا افتتاحيًا في الصراع الدائر بين الموساد وجميع أجهزة الاستخبارات في المنطقة، إلا أن هذا الصراع لم يكن يميل لكفة على حساب أخرى حتى وقت ليس بالبعيد، فكان السجال دائمًا ما بين مد وجزر، ونجاح وفشل. وقد يُعزى ذلك إلى نوع الحرب التقليدية التي كانت مستعرة بين إسرائيل وباقي أطراف المنطقة، أو تكافؤ القدرات، وحالة الاستعداد والحذر الدائم بين جميع الأطراف، أو حتى التكافؤ التكنولوجي النسبي، لأن هذا المجال كان ما زال يحبو في حقل الاتصالات إبان ذلك.
إلا أن طوفان الأقصى وتبعاته قد غيّرت المعادلة تمامًا، ووضعت منظورًا جديدًا للدور الاستخباراتي في المنطقة. فذلك السقوط الداخلي الكبير للشاباك في السابع من أكتوبر أمام المقاومة الفلسطينية، أُتبع بتفوق كاسح للموساد شرقًا وشمالًا وجنوبًا. فعملية البيجر الشهيرة، التي كانت ضربة قاصمة لحزب الله في جنوب لبنان، ثم تبعتها عملية قتل حسن نصر الله وقادة الحزب ذاته في عملية استخباراتية فائقة النجاح، سواءً اختلفنا أم اتفقنا، وذلك الاختراق الميداني الكبير في إيران، الذي بدأ منذ اغتيال إسماعيل هنية من وسط أحضان الحرس الثوري الإيراني، ثم تجنيد العملاء هناك، وتصنيع وإطلاق المسيرات الانقضاضية من الداخل الإيراني، يُعد تفوقًا استخباراتيًا كاسحًا.
إلى هنا، تكاد تُسلِّم بالتفوق التكنولوجي والعسكري، وحتى البشري، للمخابرات الإسرائيلية، ذلك بالطبع قبل أن تطرح السؤال الأهم: كيف لهم، بهذا التفوق الفارق، لم يستطيعوا استرجاع أسير واحد من حماس؟ كيف لم يستطيعوا تحديد مكان قائد واحد من قادة حماس في غزة؟ فقد قادتهم الصدفة فقط للسنوار، وعلى الرغم من تجنيد العملاء على الأرض في غزة، ناهيك عن الغطاء الجوي والصاروخي والانتشار البري، إلا أن كافة أركان هذه الآلة العسكرية والاستخباراتية الغاشمة لم تكفل النجاح الاستخباراتي الإسرائيلي أمام المقاومة.
وعندما تجمع قطع الأحجية: ذلك التكافؤ الإسرائيلي المصري وقت الحرب، والتفوق الإسرائيلي الكاسح على لبنان وإيران في أعقاب طوفان الأقصى، متزامنًا مع ذلك النجاح الاستخباراتي القاطع لحماس، تتساءل من جديد: هل كانت العزيمة، والإيمان بالقضية، وحب الوطن، والولاء المطلق له، دور في تغيير نواتج المعادلة؟ هل القدرات الفردية كانت أحد العوامل الفارقة؟ لماذا نجحت مصر وحماس فيما أخفق حزب الله وإيران؟ أسئلة تضع التكنولوجيا والعتاد في حجمهما الحقيقي، وتؤكد أن المعارك الاستخباراتية لا تُحسم فقط بالعتاد، بل إن ما يسكن في القلب والعقل كثيرًا ما يُضاهي أو يتفوق على ما يتوفر، أو حتى يُغتصب باليد.
اقرأ أيضًا:
بعد فضيحة إبستين، شقيق ملك بريطانيا يتخلى عن لقبه الملكي رسميًا
فضيحة عاطفية تضرب نجم ريال مدريد.. فينيسيوس يرضخ بعد خيانته لفيرجينيا
الأكثر قراءة
-
أرعبت الإنجليز وتبنت محمود المليجي.. من هي "الفحلة" التي ظهرت بمسلسل النص التاني؟
-
موعد مباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
-
برنامج رامز ليفل الوحش.. تعرف على ضيف حلقة اليوم
-
موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
-
عمرو الليثي سفيرا لحملة جمعية رعاية الكبد لدعم المستشفى
-
منتج "إفراج": المسلسل يتصدر المشاهدات ولدينا بيانات رسمية
-
توجيه عاجل من محافظ سوهاج بشأن أسطوانات البوتاجاز
-
ياسين أحمد السقا عن "مضغ اللبان في نهار رمضان": "ربنا يسامحهم"
أكثر الكلمات انتشاراً