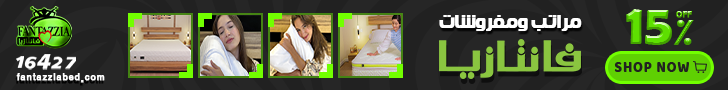كنتُ أنتظر عناقًا!
في صغري، اكتشفت أن الله أهداني صوتاً مميزاً، عذباً، ذا طبقة رنانة حزينة تطرب الأذن.
كان أبي منشغلا بتوفير حياة كريمة لنا، يعطيني ما أريد متى طلبت، ويعمل من أجل إيجاد مكان لنا بين أصدقائنا من الطبقة فوق المتوسطة، بينما كان هو رقيق الحال، إفطاره قرصا طعمية وقطعة جبن قديم معتق داخل برطمان كنت أكره رائحته، أتبطّر عليه كلما رأيته على رُخامة المطبخ.
لا بأس إذا لم يجد العشاء جاهزاً، يبتسم ابتسامة فارس امتطى حصاناً خائناً ويقول: “مش مهم، هنام خفيف”. اعتاد على التسبيح وتدخين سيجارة وترك مصروفي على الطاولة قبل النوم، لكنه كان ينسى دائماً إعطائي حضناً، يعتقد أنني أهتم بـ"المصروف". كنت أنتظر عناقاً بعد كل خسارة أتعرّض لها أو يأس تسوقني إليه قدماي أو ضربة من عصا الأستاذ جمال، مدرس الرياضيات، إذ يقول لصاحبه: "كسّر وأنا أجبس"، ويتبادلان الضحك على دموعي، وأضطر إلى استكمال الدرس متأثراً بإصابتي، لا أقدر على فهم المسألة من شدة ألم ضربة المستر. لكن لا بأس، لولا الأستاذ جمال ما كنت لأتذكر جدول الضرب حتى هذه اللحظة.
على الرغم من تكبّده مبالغ طائلة لأجلي ولأجل إخوتي، كان ينسى أن يربّت على كتفي كل ليلة، لعل أمراً ما يشغلني أو يشعرني بالخوف أو الحزن، إيماناً منه أن الرجل لا ينكسر وأنني سأصبح بخير "كدا كدا".
حينما كنت أغنّي بصوت هادئ، كانت أمي تسمعني وتردّد بسخرية: "ما كفاية يا عبدالحليم"، أتعَرَّق من شدة الحرج، لكنني أضحك. أمي كانت خفيفة الظل، لكنها امرأة حديدية حصلت على الماجستير في الرابعة والخمسين من عمرها. طيلة هذه السنين تعمل على تربية نشء لا يقدر على التفوه بكلمة خارجة عن النص. كنا نمشي على الألف خوفاً من العقاب ومن جملة “يصبح لك يفتح لك”. لن أحدثكم عن الكواليس، لكن يكفي القول إننا كنا نتمنى ألا يطلع علينا نهار اليوم التالي.
باعت من أجلي قرطها الذهبي لتشتري لي لعبة تفوق ميزانيتها. كبرتُ، وقررت أن أشتري لها عدة أقراط تغيرها كما تحب. ولم أنفذ القرار إلى الآن لأنني أعمل "صحفياً"، و"لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا".
في الابتدائية، كنت تلميذاً بشعر طويل وناعم، أبيض البشرة، خجولاً، مهذباً، شاطراً في جميع المواد عدا الرياضيات.
حبيباتي اللواتي تركتهن بنات الصف الخامس والسادس عندما كنت في "سنة رابعة"، كن يشترين صوتي بقطعة من شوكولاتة رديئة الطعم، لكنني كنت أحب أن أغني لهن. أستمتع بلمعة عيون "سارة" في غناء النشيد الوطني، وكانت "هدير" تصمّم كل يوم على سماع "أهو ده اللي صار "، بينما "منة" تحبّ عبد الحليم حافظ! وجميعهن يغدقن عليّ الشوكولاتة، وأمي تسألني كل يوم عن سبب تسوّس أسناني.
التحقت بالجامعة، في أسبوع التعارف لم يتعرف عليّ أحد، فاكتفيت بـ"أحمد جبالي"، زميل في الثانوية. شاءت الأقدار أن يكون زميل الكلية، فقررت أن يكون صديقي وتقبل الأمر، سألنا موظف رعاية الشباب ذات مرة داخل المدرج: “مين هنا صوته حلو؟”. قفز الجبالي كأسد يطبق على فريسته قائلاً: "أحمد حسن يا كوتش". كدت أتعَرَّق من شدة الإحراج، عليه اللعنة ما دام حيًّا. اضطررت للكذب وقلت: "أبداً والله يا كوتش، ما بعرف أنطق، مش أغني". كان يود أن يقتلنا نحن الاثنين، لكن عناية الرب كانت حاضرة، رن هاتفه وغادر مسرعاً.
بمجرد خروجي من القاعة، وجدت إعلاناً بمسرح الجامعة يبحثون عن أصوات عذبة لتمثيل الجامعة في مسابقة فنية. وجدت نفسي عالقاً بين العودة إلى المنزل أو دخول مسرح الجامعة.
دخلت إلى المسرح، ووجدت مجموعة صغيرة من المتقدمين، فرصة ذهبية بالنسبة لي، فأنا أخجل من التجمعات الكبيرة. بدأت بموال قديم، وما إن انتهيت حتى اعتبروني نجم الفريق الأول وحدّدوا معي موعد البروفات. خرجت من المسرح ولم أعد إلى هناك مجدداً. دخلت المسابقة فقط لأني افتقدتُ صوتي ليس إلا.
حان ميعاد حفل التخرج، رشحني أحد الأساتذة لتقديم أغنية الحفل، كان يتذكر صوتي جيداً منذ آخر مرة. لكنني قابلت الطلب برفض قاطع قائلاً: "أنا مش بتاع غنا".
في الليل استلقيت على سريري أحدّق في سقف الغرفة المظلم، سمعت لحنًا آتياً من حيث لا أعرف. أشعلت كشاف هاتفي وجلست على طرف السرير استعداداً لبدء الحفل. ومن ثم بدأت بالغناء:
"ومكنتش أعرف قبل النهارده
إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده
ولا كنت أصدّق قبل النهارده
إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده
جبار.. جبار"
أتذكر أدائي تلك المرة جيداً، كنت أغنّي أفضل من العندليب. الفرق أنه كان على خشبة المسرح وسط عيون المحبين والمعجبين، بينما كنت وحيداً على طرف سرير، وكان أبي منشغلاً بتوفير حياة كريمة وأمي تعمل على تربية نشء لا يخرج عن النص أبداً.
الأكثر قراءة
-
بعد عامين من شطبها ببورصة طوكيو، مجموعة العربي تنهي الشراكة مع توشيبا
-
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
-
41 مليار جنيه في الظل، ألعاب المراهنات الإلكترونية تنهش جيوب 5 ملايين مصري
-
استدعاء مرتقب لنادية الجندي للتحقيق في بلاغ قذف وتشهير، ما القصة؟
-
"هرسوا راسه بالكوريك"، مصرع شاب على يد بلطجية في الوادي الجديد
-
"تعالى اشتري مني"، بائعة ثوم تستوقف محافظ الأقصر خلال افتتاح سوق اليوم الواحد
-
نجيب ساويرس يحذر من ركود محتمل في السوق العقاري، ما الأسباب؟
-
حظك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، توقعات برج السرطان
مقالات ذات صلة
بـ5.2 مليار جنيه، تحالف مصرفي يمول مشروع "جيفيرا" بالساحل الشمالي
22 أكتوبر 2025 10:27 ص
"الحسد جابلهم المرض".. أم تناشد لإنقاذ طفليها بزراعة قلب (فيديو)
09 ديسمبر 2024 01:17 ص
"حديد عز" تقرر الشطب الاختياري من البورصة المصرية
08 ديسمبر 2024 02:27 م
سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23 نوفمبر 2024
23 نوفمبر 2024 07:40 ص
أمي.. "أمل محفوظ"
15 نوفمبر 2024 02:00 م
معركة حفيد النبي
30 أكتوبر 2024 09:36 م
راح فين زمن الشقاوة.. مصطفى فهمي "ابن باشا" سحر "الشاشة"
30 أكتوبر 2024 06:30 ص
حفيد النبي
12 أكتوبر 2024 03:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً