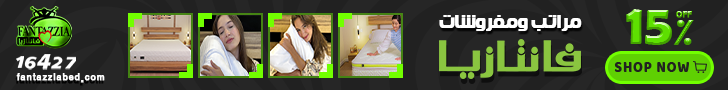بعدهما صار العالم ناقصًا.. سيرة الحزن حين يفقد الإنسان جذوره
ليس الفقد حدثًا يقع وينتهي، بل حالة وجودية تبدأ ولا تُغلق أبوابها. حين يرحل الوالدان، لا يختفي شخصان من حياتنا فحسب، بل ينهار نظام كامل من الطمأنينة، ويتصدّع المعنى، ويصير العالم مكانًا أقل رحمة، وأكثر برودة، بعدهما، لا يعود الإنسان كما كان، ولا تعود الحياة على هيئتها الأولى، بل يصبح كل شيء مشوبًا بنقصٍ غامض لا يُسمّى.
منذ رحيل أمي ثم لحقت به أبي، في عامي 1998 و1999، وأنا أعيش إحساسًا دائمًا بأنني أسير في الحياة بلا جذور، كأن الأرض التي كنت أقف عليها بثبات قد سُحبت من تحتي فجأة، وتركتني أتعلم المشي فوق فراغ.
لم يكن غيابهما مجرد حزن عابر، بل تحوّل عميق في الإحساس بالزمن، وفي طريقة النظر إلى الأيام، وفي معنى الاستمرار ذاته.
قبل رحيلهما، كنت أعيش الأمان دون أن أراه، كان الأمان شيئًا طبيعيًا، لا يُفكَّر فيه ولا يُحلَّل، كنت أعلم أن هناك من ينتظرني، من يدعو لي في صمت، من يشعر بقلقي قبل أن أنطق به.
وجود الوالدين كان جدارًا غير مرئي يحجب عني قسوة العالم، حتى وأنا أظن أنني أواجه الحياة وحدي، لم أدرك قيمة هذا الجدار إلا حين انهار.
كان شهر رمضان، في حضرتهما، زمنًا مختلفًا عن سائر الأزمنة، لم يكن شهرًا يُقاس بعدد أيامه، بل بعمق ما يتركه في الروح، كانت المائدة تجمعنا لا على الطعام فقط، بل على السكينة، وكان الدعاء يُقال بنبرة تشبه اليقين، ويصل إلى القلب قبل أن يصل إلى السماء، كنت أجلس بينهما، أستمتع بوجودي ووجودهما، دون أن أعلم أنني أعيش لحظات لن تتكرر.
بعد الغياب، صار رمضان امتحانًا قاسيًا للذاكرة، يأتي الشهر كما كان، لكن روحه لا تأتي، أصوم، لكن قلبي مفطور على الحنين، أستمع إلى الأذان، فلا أسمع فيه إلا أصواتًا قديمة تسبق الصوت الحقيقي، فقدت القدرة على الشعور الكامل، وصرت أعيش الطقوس من الخارج، بينما الداخل يضجّ بالغياب.
سنوات طويلة قضيتها مفطرًا على موائد الرحمن، لم أكن أذهب إليها بدافع الحاجة، بل بدافع الوحدة، كنت أبحث عن دفءٍ يشبه دفء البيت القديم، عن إحساسٍ جماعي يعوّض فقدان العائلة، أجلس بين الناس، أشاركهم الطعام والدعاء، لكن قلبي كان يجلس في مكان آخر، على مائدة غائبة، في بيت صار ذكرى، هناك أدركت أن الإنسان قد يكون محاطًا بالوجوه، ومع ذلك يظل وحيدًا إن فقد من كان يمنحه الشعور بالانتماء.
الأعياد بعد الوالدين لا تأتي كما كانت، تفقد بهجتها، وتتحول إلى طقوس شكلية، لا فرح حقيقي، ولا انتظار، ولا دهشة صباحية، أرتدي ثياب العيد، لكن داخلي يرتدي الحزن، أبادل الناس التهاني، بينما روحي مشغولة بسؤال واحد: كيف يكون العيد بلا من كانوا يصنعونه؟ كيف يفرح القلب وقد فقد مصدر فرحه الأول؟.
الغربة التي يعقبها فقدان الوالدين ليست غربة مكان، بل غربة نفس، أن تعيش في بيتك وتشعر أنك عابر، أن تمشي في الشوارع التي كبرت فيها، فلا تشعر بأنها تعرفك، أن تنجح وتستمر وتضحك أحيانًا، لكنك في العمق تشعر أن شيئًا أساسيًا قد انكسر ولن يُصلح، الوالدان ليسا فقط بداية الحياة، بل هما استمرارها الخفي، وحين يرحلان، يصبح الاستمرار مجهودًا يوميًا شاقًا.
تعلمت مع الوقت أن الزمن لا يشفي هذا النوع من الفقد، لكنه يعلّمنا كيف نتعايش معه، نتعلم كيف نخفي وجعنا خلف الكلمات، وكيف نبدو متماسكين بينما الداخل هشّ، نتعلم كيف نواصل الحياة لا لأننا أقوياء، بل لأننا مضطرون.
بعض الأحزان لا تُنسى، بل تتحول إلى جزء من تكويننا، إلى ظلٍّ يرافقنا أينما ذهبنا.
هذا المقال ليس رثاءً، بل محاولة للفهم، فهم كيف يصبح الإنسان غريبًا بعد أن يفقد جذوره، وكيف تتحول الحياة إلى مسافة طويلة من الحنين، وكيف نصبح أبناء الذاكرة أكثر مما نحن أبناء الحاضر.
وفي النهاية، لا يبقى لنا سوى الدعاء، بوصفه آخر أشكال القرب.
اللهم ارحم أبي وأمي رحمةً تليق بما زرعاه من طمأنينة في قلبي، واجعل غيابهما نورًا لا ظلمة، وسكينة لا وجعًا، واجمعني بهما في دارٍ لا فقد فيها ولا حزن ولا غربة.
رحمهما الله، وجعل ذكراهما حياةً لا تنتهي في روحي.
اقرأ أيضًا..
الأكثر قراءة
-
رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية 2026 للاستعلام عن النتائج
-
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري محافظة الشرقية 2026
-
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2026
-
جلسة صلح تحولت لمجزرة.. تفاصيل إنهاء حياة صاحب شركة سيارات بفيصل
-
احصل عليها الآن.. نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2026 رسميًا
-
رابط بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن النتائج برقم الجلوس 2026
-
برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الابتدائية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف
-
نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الأول 2026، احصل عليها الآن
مقالات ذات صلة
الدراما المصرية.. مرآة الذات وعمران الروح في بيوت الناس
26 يناير 2026 10:54 ص
التعليم بين حقٍ تؤكده الدولة وأحكامٍ لا تُنفذ!
19 يناير 2026 01:25 م
الدراما في زمن الورش.. سقوط المعنى
12 يناير 2026 09:47 ص
وهم الإمبراطورية.. كيف يُصنَع الخوف من أمريكا أكثر مما تصنع أفعالها؟
04 يناير 2026 07:23 م
أكثر الكلمات انتشاراً