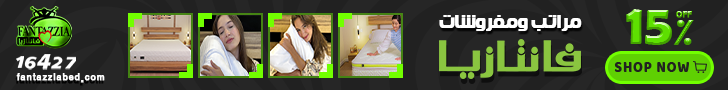الدراما في زمن الورش.. سقوط المعنى
ما كانت الدراما المصرية في أزمانها العميقة، تلك التي يصح أن نُسميها زمن التأسيس لا زمن الحنين، مجرد حكايات تُروى وتُنسى، بل كانت فعلًا معرفيًا مركّبًا، يشتغل في طبقات الوعي كما تشتغل الطبقات الجيولوجية في باطن الأرض؛ تراكمًا صامتًا، بطيئًا، لكنه بالغ الأثر، يغرس في النفس حواسًّا جديدة لفهم المجتمع والإنسان والزمان، ويحوّل الشاشة إلى فضاء للتأمل والتحليل لا مجرد مسرح للصخب أو التسليّة العابرة.
كانت الدراما آنذاك، قبل أن تتحول إلى منتج استهلاكي، امتدادًا طبيعيًا للنص الأدبي، حيث تتحول الرواية والقصة إلى حبال تربط الزمن بالإنسان، والفكرة بالشعور، والحكي بالوعي، فتصير المشاهدة تجربة معرفية، لا مجرد متابعة سطحية للمشهد.
في هذا الإطار، لم يكن الكاتب مجرد صانع حوار أو منسّق مشاهد، بل شاهدًا على عصره، يكتب وكأنّه ينقّب في ذاكرة المجتمع، ويعيد إنتاجها بصياغة درامية. وقد برز جيل من الكتّاب الذين لا يمكن النظر إليهم كأسماء متفرقة، بل كتكوين فكري متماسك، متشابك الأصوات، موحّد الرؤية، أسس للدراما بوصفها خطابًا ثقافيًّا، لا منتجًا ترفيهيًّا.
أسامة أنور عكاشة، يسري الجندي، محفوظ عبد الرحمن، محمد جلال عبد القوي، محسن زايد، ومحمد السيد عيد؛ هؤلاء جميعًا كتبوا للوعي الجمعي، واشتغلوا على الإنسان بوصفه نتاجًا للتاريخ والمكان والطبقة والسلطة، لا كائنًا معزولًا يُستدعى وقت الحاجة الدرامية ثم يُلقى جانبًا.
وذكّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، بأهمية الدراما المصرية ووجوب أن تعود إلى قيمتها الحقيقية وإلى ما كانت عليه في الماضي، حيث كانت نصوصها مأخوذة من الأدب الحقيقي، تُغذي الفكر والوجدان، وتعيد للمشاهد إدراك العلاقة بين القصة المكتوبة والحدث المصور.
هؤلاء الكبار كتبوا الدراما كما تُكتب المدن القديمة، بشوارعها وبيوتها، بحيّزاتها العامة والخاصة، وبطبقاتها الاجتماعية المتعددة.
أسامة أنور عكاشة أعاد رسم الخريطة الاجتماعية لمصر الحديثة، فحوّل الصراع الطبقي إلى بناء درامي متماسك، هادئ لكنه عميق، لا يحتاج إلى صراخ ليكون فادحًا.
يسري الجندي غاص في أعماق الوجدان الشعبي، لا ليستعرضه، بل ليكشف مناطقه الداخلية، حيث تمتزج الأسطورة بالحياة اليومية، وحيث تولد الحكمة من المعاناة لا من التنظير.
محفوظ عبد الرحمن تعامل مع التاريخ بوصفه كائنًا حيًّا، يعود بأقنعة مختلفة، فحوّل السيرة والتاريخ إلى أسئلة حارقة عن العدالة والمصير والحرية، متجاوزًا الحنين السطحي إلى الماضي، إلى قراءة معاصرة تغوص في ثنايا الحاضر.
محمد جلال عبد القوي كتب الزمن بوصفه استمرارًا عضويًّا، لا كسلسلة قطيعات، وربط الخاص بالعام دون شعارات جاهزة.
محسن زايد منح الإنسان البسيط عمقًا إنسانيًّا ووجوديًا، فحرّره من صورة الضحية المسطّحة، بينما جاء محمد السيد عيد حاملاً قلقًا فلسفيًّا وإنسانيًّا، جعل من الدراما فضاءً لطرح أسئلة العدالة والمعنى والوجود، لا منصة للإجابات السطحية.
هؤلاء جميعًا لم يشكّلوا مجرد تيار فني، بل أسّسوا وعيًا، وخلقوا وجدانًا، وربّوا عينًا ترى وسمعًا يميز، علموا المشاهد أن الدراما لا تحتاج إلى فجاجة أو صخب، بل إلى الصدق في التشخيص وفهم النفس البشرية، وإلى أصالة النص الأدبي كجذر لكل صورة مصورة.
ولم يكن من قبيل الصدفة أن أكثر الأعمال التي صمدت أمام الزمن، كانت مأخوذة عن روايات أو قصص أدبية، فالأدب بطبيعته ابن التأمل والبطء، والفهم العميق للإنسان والمجتمع، لا ابن الاستعجال والاستهلاك.
فالعمل الدرامي حين يُشتق من أصل أدبي متين، يأتي محمّلًا بطبقات نفسية ومعنوية لا تُنتجها الورش الجماعية، ولا تُخلقها الكتابة السريعة. الرواية تمنح النص عمقًا داخليًا، وتجعل الحوار نتاجًا حقيقيًا لتجربة الإنسان، لا وسيلة لتسلية فارغة أو لجذب الانتباه اللحظي.
هنا يتضح أن العلاقة بين الأدب والدراما ليست مجرد خيار فني، بل هي جوهر وجودي للدراما نفسها، لتظل شاشةً تعكس وعي المجتمع لا مجرد صخب أو إبهار بصري.
ومن هنا تبرز ضرورة اكتشاف المواهب الأدبية الجديدة، ليس كرفاهية ثقافية، بل كضرورة وجودية لإنقاذ الدراما من الانحدار.
في الهوامش، كتّاب الرواية والقصة يملكون عوالم كثيفة وغنية، لكنهم مغيبون عن الشاشة لأن زمن الصخب لا يسمع إلا صوته. ولو أُعيد فتح الجسور بين الأدب والدراما، لاستعادت الشاشة عمقها، ولعاد النص سابقًا على الصورة، لا تابعًا لها، ولأصبح العمل الدرامي امتدادًا طبيعيًا للمكتبة، لا بديلًا عنها، وحينها ستعود الدراما كما أرادها الروائيون والكتّاب: مساحة للمعرفة والوجدان، لا مجرد عرض للمشهد.
على الضفة الأخرى، تقف الدراما المعاصرة وقد انفصلت عن هذا الإرث الأدبي والمعرفي، وتبدو في كثير من نماذجها مشلولةً أمام تعدد الأصوات، وكأنها فقدت العقل الجامع. ظهرت “ورش الكتابة” كحل تنظيمي، لكنها تحولت غالبًا إلى تعدد أصوات بلا رؤية موحدة. يُكتب المسلسل بأيدي كثيرة، لكن بلا ذاكرة مشتركة، فتخرج الشخصيات متقلبة، والأحداث بلا منطق تراكمي، والحوار أقرب إلى صخب عابر منه إلى بناء إنساني طويل النفس، فتتحول الدراما إلى مجرد تجميع مشاهد، لا بناء دلالي، ولا امتدادًا للأصل الأدبي الذي يمنحها الحياة.
ومع هذا التفكك، تسللت لغة الإسفاف، وأصبحت الشتائم والألفاظ البذيئة بديلًا عن الفكرة، وتعويضًا عن ضعف النص، لا عن قسوته. ارتفع الصوت، وانخفض المعنى، وغاب الصراع الداخلي ليحلّ محلّه الانفعال الفج، كأن الدراما فقدت ثقتها في عقل المشاهد، فاختارت أن تصدمه بدل أن تحاوره، وأن تلاحقه بالصخب بدل أن تحاصره بالسؤال.
وهنا يصبح الحديث عن مراجعة النصوص الدرامية أمرًا حضاريًّا، لا رقابة أخلاقية ضيقة، فالنص يحتاج إلى إدارة واعية، تمتلك معيارًا معرفيًا وأخلاقيًا، تميّز بين الجرأة والابتذال، وبين النقد والترويج للقبح، وبين الواقعية والفجاجة، وبين الصدق الأدبي والصخب السطحي. فالكلمة التي تُقال على الشاشة لا تموت بانتهاء الحلقة، بل تستقر في اللغة، وفي الذوق العام، وفي العقل الجمعي للمجتمع.
الدراما التي صنعها الكبار لم تكن مثالية، لكنها كانت مسؤولة، واجهت الواقع دون أن تستسلم له، وانتقدت القبح دون أن تحتفي به، واشتغلت على العقل قبل الانفعال، أما كثير من دراما اليوم، فتبدو وكأنها تخلت عن هذا الدور، واكتفت بأن تكون صدى مرتفعًا لفوضى بلا معنى.
إن استعادة عافية الدراما المصرية لا تبدأ من التقنية ولا الميزانيات، بل من العودة إلى الأصل: الكاتب بوصفه مثقفًا، والنص بوصفه معرفة، والأدب بوصفه الجذر العميق لكل صورة باقية.
وحين تُؤخذ الدراما من الرواية والقصص الأدبية، وحين يُكتب النص بالحبر لا بالصخب، ستستعيد الشاشة مكانتها الطبيعية: عقلًا جمعيًا يُنير، ووعيًا يربّي، وشاشةً تُثرِي الوجدان لا تُكثر الصخب.
اقرأ أيضًا…
الأكثر قراءة
-
خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية 2026، كل ما تريد معرفته
-
إخماد حريق داخل محل كبير لبيع الملابس والأجهزة الرياضية بأسيوط
-
موعد وقفة عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
-
حقيقة وقف الطيران بين مصر والسعودية، آخر التطورات
-
خط "سوميد".. أمل نفط الخليج للعبور إلى أوروبا من مصر
-
بعد "عين سحرية"، لماذا لا يكفي تاريخ الصلاحية لتحديد سلامة الدواء؟
-
مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات بـ"الإسماعيلية الصحراوي"
-
ترند "مريم" يجتاح مواقع التواصل في رمضان.. ما علاقته بالدورة الشهرية؟
مقالات ذات صلة
التحالف الأمريكي _ الإسرائيلي.. شراكة استراتيجية أم مفصل قوة في هندسة العالم؟
02 مارس 2026 08:59 ص
رامز جلال بين الترفيه المبتذل والإبهار الفارغ
23 فبراير 2026 09:38 ص
رمضان.. سيرة النور في دفاتر القلب
16 فبراير 2026 10:38 ص
بعدهما صار العالم ناقصًا.. سيرة الحزن حين يفقد الإنسان جذوره
02 فبراير 2026 10:05 ص
أكثر الكلمات انتشاراً