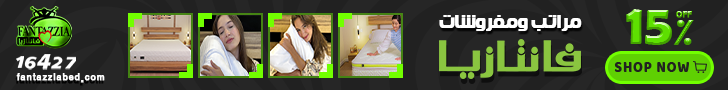رسالة مفتوحة للأعلى للجامعات الخاصة.. إقطاعية البيه المدير؟!
“القانون حمار لمن يعرف كيف يركبه”، عبارة قاسية في ظاهرها لكنها شديدة الصدق في جوهرها، تداولها الأدب الإنساني قبل أن تتداولها ساحات الواقع، فنجد جذورها عند شكسبير، ثم تتجسد بوضوح في أعمال الكاتب والأديب الإنجليزي الشهير تشارلز ديكنز، ولا سيما في رواية “أوليفر”، حين قدّم صورة لمدينة لندن في القرن التاسع عشر، مدينة تحكمها النصوص لكنها تفتقر إلى العدالة، الصورة ذاتها، وإن اختلف الزمان والمكان، رسمها الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ في القاهرة مطلع ومنتصف القرن العشرين، حين تحولت القوانين في عوالمه الروائية إلى أدوات تستخدم داخل سياق اجتماعي غير عادل، وبين شكسبير وديكنز ومحفوظ، يبقى السؤال واحدا ومتجددا هل تكمن المشكلة في القانون ذاته أم فيمن يملك سلطة تفسيره وتطبيقه؟ وهذا ليس استدعاء أدبيا بقدر ما هو مفتاح لفهم واقع معاصر تتكرر فيه المأساة حين يفرغ القانون من روحه ويستخدم نصا لا عدلا.
في الأصل، ووفق أبسط مبادئ الفكر الأكاديمي، تبنى الجامعة على ثلاث ركائز لا تستقيم إحداها دون الأخرى: الحرية العلمية، والعدالة المؤسسية، والجودة التعليمية، وحين تتآكل ركيزة العدالة، لا يسقط فرد واحد فقط، بل تتداعى المنظومة بأكملها، مهما بدا شكلها الخارجي منضبطا أو لامعًا، فالقضية ليست صراعا إداريا عابرا، بل اختبار حقيقي لمدى احترام الجامعات الخاصة لجوهر الفكرة الجامعية ذاتها.
تتكرر شكاوى أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الخاصة بوتيرة لم تعد قابلة للإنكار، شكاوى تتعلق بتعنت مالي، وتسلط إداري، وتعطيل متعمد لمسارات الترقية، وتجاهل معايير الجودة، الأخطر أن هذه الممارسات لا تقدم بوصفها استثناءات، بل تدار أحيانًا كأنها حق أصيل للإدارة، لا يخضع لرقابة ولا مساءلة، في تناقض صارخ مع كل ما يدرس عن الحوكمة الرشيدة والشفافية.
النموذج الذي نطرحه هنا ليس حالة فردية بقدر ما هو مرآة مكبرة لأزمة أعمق، أستاذ جامعي معروف بالكفاءة العلمية والنزاهة المهنية، يعمل في واحدة من الجامعات الخاصة، ويشارك بفاعلية في التدريس والتطوير الأكاديمي داخلها وخارجها، ويستوفي متطلبات الترقية وفق اللوائح المعتمدة، غير أن سعيه المشروع نحو الترقية كشف خللا لا يليق بمؤسسة تعليمية: مسار غامض، قرارات غير معلنة، وصمت إداري يقترب من كونه سياسة متعمّدة.
كيف يجرؤ عضو هيئة تدريس أن يترقى في كلية لا يوجد بها أستاذ أصلًا؟ وكيف تتحول الترقية من إجراء علمي منضبط إلى اختبار للقدرة على الصمت أو القبول بالأمر الواقع؟ الأسئلة هنا ليست إنشائية، بل جوهرية، لأنها تكشف منطقا مقلوبا يدار به بعض التعليم الخاص: منطق يبقي الأستاذ مؤهّلًا طالما لم يطالب بحقه، ومزعجا بمجرد أن يفعل.
الأكثر قسوة أن هذه الرحلة لم تنتهِ عند حدود التعطيل، بل امتدت إلى الإقصاء، منع من دخول الجامعة، وقطيعة إدارية تفتقر لأي مسار قانوني واضح، وكأن المؤسسة التعليمية قررت أن تغلق الملف بدل أن تُديره، وهنا لا يمكن قراءة المشهد إلا بوصفه تعبيرا عن اختلال ميزان السلطة داخل بعض الجامعات الخاصة، حيث تُستخدم الإدارة لا لتنظيم العمل الأكاديمي، بل لضبط الأفراد وإخضاعهم.
حين لجأ الأستاذ إلى الجهات الأعلى، وتحديدا الأمانة العامة للجامعات الخاصة، جاءه الرد بأن الأمر خارج نطاق الاختصاص، هذا الرد، في حد ذاته، يفتح بابا أخطر من الواقعة الأصلية: إذا لم تكن الجهة المشرفة مختصة بحماية المسار الأكاديمي داخل الجامعات الخاصة، فمن المسؤول إذن؟ وأين تذهب شكاوى أعضاء هيئة التدريس حين تصبح الإدارة المحلية خصما وحكَما في الوقت نفسه؟
هنا تتجلى المعضلة الحقيقية: فراغ رقابي إداري من الأعلى للجامعات الخاصة يسمح بتحول بعض الجامعات إلى كيانات شبه مغلقة، تدار بمعايير داخلية غير قابلة للمساءلة، وتقدم للخارج بواجهة الجودة والاعتماد، بينما تدار من الداخل بمنطق القوة لا القانون، وفي مثل هذا المناخ، لا تكافأ الكفاءة بالترقية، بل تعاقب بالاستبعاد، وينظر إلى الأستاذ لا بوصفه قيمة مضافة، بل كعنصر قابل للاستبدال.
أي نظام تعليمي يفقد العدالة المؤسسية يفقد تلقائيا مصداقيته الأكاديمية، وأي أستاذ يشعر بعدم الأمان الوظيفي لا يمكنه أن ينتج تعليمًا عالي الجودة، ولا أن يزرع في طلابه قيم الاستقلال والنقد والابتكار، أما عن الظلم حين يتسرب إلى الجامعة يصبح أكثر خطورة، لأنه يمارَس باسم العلم لا ضده.
إن التعليم العالي الخاص لا يقاس بعدد المباني أو قيمة المصروفات، بل بمدى احترامه للعقل الذي ينتج المعرفة داخله، وتحويل الجامعة إلى مساحة طاردة للكفاءات، أو إلى بيئة يُكافَأ فيها الصمت ويُعاقَب فيها السؤال، لا يضر أفرادًا بعينهم فحسب، بل يضرب فكرة الجودة في صميمها.
السؤال الذي لا يمكن الهروب منه: من يحمي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة؟ وهل يعقل أن تبقى مصائرهم المهنية رهينة قرارات إدارية غير قابلة للمراجعة؟ إن غياب آليات واضحة للفصل في شكاوى الترقية والتعسف يخلق نظاما تعليميا هشا، يتعايش ظاهريا مع الاعتماد والجودة، بينما يفتقد في جوهره أبسط مقومات العدالة.
إن التدخل المطلوب ليس تصعيدا ولا خصومة، بل تصحيح مسار، تدخل يرسخ قواعد شفافة للترقية، ويضع حدودا واضحة للسلطة الإدارية، ويؤكد أن الجامعة ليست إقطاعية، ولا الأستاذ تابعًا، فحين تصان كرامة عضو هيئة التدريس، تصان الجامعة، وحين تترك العدالة رهينة الصمت، يصبح التعليم نفسه هو الخاسر الأكبر.
حين بحثت اكتشفت أن القوانين المنظمة للتعليم العالي في مصر لا تمنح إدارات الجامعات الخاصة سلطة مطلقة، بل تقيدها بضوابط واضحة تضمن العدالة، والاستقرار الوظيفي، والشفافية، وحق الترقية، وأي ممارسة تخالف هذه القواعد لا تمثل مجرد خطأ إداري، بل انحرافا عن فلسفة التعليم العالي ذاتها، وتستوجب تدخل الجهات الرقابية المختصة، إن المشكلة، في جوهرها، ليست غياب النصوص، بل غياب تفعيلها، وتحول بعض اللوائح من أدوات حماية إلى أوراق صامتة، وهو ما يفرض ضرورة المراقبة الجادة، لا الاكتفاء بالموافقة الشكلية.
يا معالي الأمين العام الخاص، ويا دكتور أيمن عاشور، مجلسكم جهة رقابية عليا يفترض أن تكون ملاذا مؤسسيا لحماية التوازن داخل المنظومة التعليمية الخاصة، هذا نداء واجب لا يحمل سوى تحذيرا صادقا، اصحوا قليلا على ما يجري داخل الجامعات الخاصة، لا تنسى أن اسمها وزارة التعليم العالي، لكن أعتقد أنه يجب أن يضاف إليها أيضا التربية، التعليم حين تنفصل عنه التربية الإدارية والأخلاقية يتحول إلى إجراء بلا روح، وشهادات بلا مضمون، وجامعات تدار بالسلطة لا بالقانون، رقابتك ليست ترفا، والمتابعة ليست مجاملة، وحماية عضو هيئة التدريس ليست منة، بل جوهر المسؤولية ومعنى الولاية على منظومة يفترض أنها تصنع العقل قبل أن تمنح اللقب، فإذا غابت التربية عن التعليم العالي، غابت العدالة، وتآكلت الهيبة، وتحولت الجامعة من منارة للمعرفة إلى مؤسسة لا تسمع إلا صوت الإدارة ولا ترى إلا ما يخدمها.
الأكثر قراءة
-
قتلت على يد خادمتها، من هي الممثلة السورية هدى شعراوي؟
-
"يا نبي سلام عليك".. الأمن يلاحق ناشر أغنية مسيئة للرسول
-
الذهب يتعرض لأكبر هبوط منذ أكتوبر مع صعود الدولار، ما مصير عيار 21؟
-
نتيجة الشهادة الإعدادية في كل المحافظات ترم أول 2026 بالاسم ورقم الجلوس
-
بلاغات ضد أغنية "يا نبي سلام عليك" بسبب عبارات مسيئة.. ماذا قال صاحبها؟
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم الترم الأول 2026
-
مشهد صادم.. الأمن يفحص فيديو دهس كلب رغم نباح أمه بحلمية الزيتون
-
القبض على أصحاب ترند "صل على النبي”
مقالات ذات صلة
خطة طموحة ومسؤولية مؤسسية.. جامعة القاهرة أمام اختبار الأولويات
27 يناير 2026 12:40 م
في قبضة أهواء المنسقين.. الوجه الخفي لأزمة البحث العلمي
18 يناير 2026 10:54 ص
"الثقافة" في عيدها.. لحظة مراجعة أم صورة تذكارية مكررة؟
07 يناير 2026 11:05 ص
الثقافة الرسمية خارج العصر.. حين تدار جوائز الدولة بلا منصة رقمية
31 ديسمبر 2025 11:29 ص
أكثر الكلمات انتشاراً